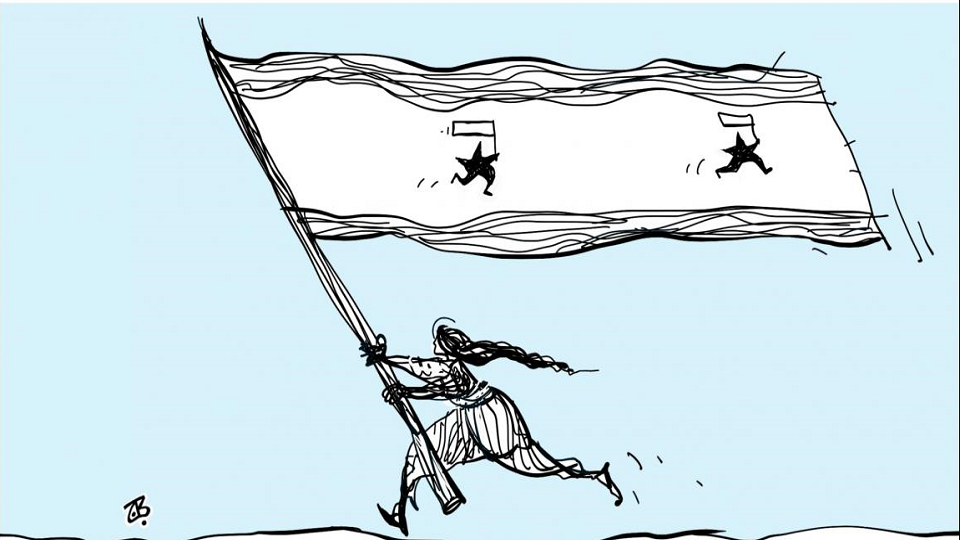اقتصادي – خاص:
في هذا الجزء من المقالات المتسلسلة سنركز على مفهوم الدولة وماذا يعني وجودها..؟!! وماذا يعني غيابها..؟!! وأيهم الافضل للثورة السورية إعادة بناء الدولة أم إعادة هيكلتها..؟!!
مفهوم الدولة، كي لا ندخل في جدال عقيم حول مفهوم الدولة، وهو مفهوم مختلف بحسب المرحلة الزمنية أو النظام السياسي الذي يتبناها، لذا سنعتمد على المفهوم الذي طرح في الثورة السورية خلال حراكها منذ البداية حتى تاريخ كتابة هذه المقالة.
طالبت الثورة بدولة حديثة، ومن خلال النقاشات المباشرة مع الثوار من مختلف فئات الحراك السلمي والعسكري، ومن النخبة السياسية إلى الشباب على الأرض، كان المقصود بالدولة الحديثة، الدولة المدنية الحديثة، وبالعودة إلى أدبيات مفهوم الدولة المدنية الحديثة في الكثير من المؤلفات المتنوعة، وجدنا انه مفهوم يشوبه غموض كثيف يجعل من محاولة الإمساك به أمراً صعباً مهما كانت أداة التحليل المستخدمة، أكانت من خلال العلوم الاجتماعية والسياسية السائدة أم كانت النظرية الماركسية أو الليبرالية نفسها، وتطبيقاته في التحليل الملموس للوقائع يتراوح من الشيء إلى نقيضه، ولعل أهم ما وجدناه هو أن دور الدولة المركزي في المجتمع يقع في صميم معظم برامج القوى السياسية التي تطمح إلى استلام زمام السلطة وخصوصاً في المنطقة العربية، حتى الليبرالية أظهرت في آخر كتاباتها مثل “فرانسيس فوكوياما” نزعة نحو مركزية الدولة في أداء دورها، لذا فإن مفهوم الدولة الذي يناسب الطرح الذي قدمه الثوار في سوريا، يتناسب مع ما طرحته العديد من كتابات المثقفين، وهو أن مفهوم الدولة المدنية الحديثة يتضمن بشكل أساسي دولة تقوم على الانتخابات “الحرة” وعلى فصل السلطات الثلاث مع تعددية سياسية وحزبية، وهو ما يعني بكلمات أخرى أبسط، وأقل زخرفة وأكثر دقة، الديمقرطة أو ما يسمى بدولة القانون، وبذلك تكون سيرورة الدولة تقوم على نتائج وواقع الصراع الاجتماعي السلمي المدروس، وهي ليست أمرا مرهونا فقط برغبة دوائر الحكم ومصالحها الخاصة الضيقة، وهو تعبيراً صريحاً وواضحاً عن مواجهة الدولة الاستبدادية الحالية أو ما تسمى بالدولة السلطانية، كما سمتها كتابات عبد الله العروي، الدولة التي يحكمها سلطان أو رئيس، لا خلاف لأن التصرف واحد، يقول إنه “خليفة الله” في أرضه.. أي أن لا عدل في الأرض إلا تحت رايته وأن “الله” أورثه الأرض ومن عليها، إنها مقاربة تاريخية لا أكثر، وإن طبيعة “الدولة السلطانية” حسب سلاطينها تمنح لهم المبرر باستخدام مؤسسات الدولة لتفكيك المجتمع إلى “جماعات أهلية وجهوية” أي حالة ما قبل العصر الحديث، باستخدام ما يملكون من سيطرة على السلطة التشريعية والتنفيذية لتقليص- إن لم يكن إلغاء- أهمية دور العلاقات الاجتماعية في المجتمع وبالتالي الدولة، وذلك بهدف الاستمرار في السيطرة على السلطة وتحديد طبيعة الدولة حسب مصالحهم، ما يجعل المهمة الأساسية للعمل المعارض والمثقفين، من وجهة نظرنا، تنصب في محاولة إنتاج هوية وطنية، وإظهار مفهوم “الدولة المدنية الحديثة” السابق الذكر، بشكله العملي من خلال تطبيقه على أرض الواقع بالتحول الديمقراطي، وانطلاقاً من قاعدة أن سيادة القانون تشكل شرطاً أساسياً من شروط المجتمع المدني الحديث، المأمول تحقيقه من قيام الثورة.
فدولة القانون هي الدولة المدينة الحديثة والديمقراطية، هي دولة يتم فيها توزيع السلطة واقتسامها لا على أفراد بل على مؤسسات: مؤسسات تشريعية، مؤسسات تنفيذية، مؤسسات قضائية.
وما يوحد ويربط بين هذه السلطات الموزعة هو وحدة الفضاء القانوني الذي يرسم لكل سلطة مجالها واختصاصاتها وحدودها فالمعيار والمرجع والحكم في دولة القانون هو القانون سواء تعلق الأمر بالقانون الأساسي الذي هو الدستور أو بالقوانين الفرعية.
وتقوم دولة القانون (الحديثة) على إحلال العلاقات القانونية محل العلاقات الوجدانية والقرابية (العائلية) والعرقية والمهنية والمالية والأخلاقية والدينية وغيره، وبالتالي هنا ينعدم وجود قومية واحدة او ثنائية او عدة حتى، لأن المواطنة حققت التساوي الذي يطمح له الشعب، فمن خلال وجود القومية “التي تسبب ظلم لمن لا ينتمي لهذه القومية حسب محددتها السابقة، والتي قد تكون عرقية” فسلطة القانون هنا هي السلطة المرجعية الأعلى التي تستمد منها كل الهيئات والقطاعات والممارسات والتيارات مرجعيتها الرسمية .
ماذا يعني وجود دولة! إن وجود دولة ما مرتبط جوهريا بوجود المجتمع، وبدون المجتمع لا توجد دولة، ولا يمكن أن يقوم مجتمع ويدوم دون نظام سياسي يحكمه, فالدولة ضرورية في حياة الأفراد لحماية أملاكهم وتطوير حريتهم, وتظهر هذه الافكار جلياً في الكتابات الأولية للعقد الاجتماعي الذي وجد مع تكوّن أول دولة وفق تشريعات حمورابي، لتتبلور هذه الأفكار بالعقد الاجتماعي في كتاب [العقد الاجتماعي] للفرنسي “جون جاك روسو” الذي يعتبر الأب الروحي لصياغة العقد الاجتماعي للثورة الفرنسية، فقد جاء فيه {الدولة شكل لشراكة تحمي كل شخص وأملاك كلّ مشارك في الجماعة فكأنه لا يطيع إلاّ نفسه ويبقى حرًّا كما كان من قبل}، وحجته أن من يهب نفسه وحياته للجميع لا يهب نفسه إلا لنفسه، لأنه عندم يهب نفسه للآخرين فإن الآخرين يهبوه أنفسهم، وبالتالي هو يحقق ذاته عند اختياره العقد الاجتماعي بإرادته، والدولة هي الضامن الوحيد للحرية {إن مصلحة المواطن وحريته مضمونان في مصلحة وجوهر الدولة} كما ذهب إلى ذلك “هيغل”، حيث أنه من الناحية الواقعية مطالب الإنسان كثيرة وقراراته محدودة فهو بحاجة إلى مجتمع منظم لتلبية مطالبه، وهي ضرورية بالنظر إلى عجز الفرد عن الاكتفاء بذاته.
وبالرغم من استخدام القمع من قبل حكومات استبدادية كثيرة (في العصر الحديث) ابتداء من النازية وانتهاءً بالحكم الاسدي في سوريا، إلّا أن سوء تطبيق مفهوم الدولة لا يعيب مفهومها وإنما يشير إلى ضعف العقد الاجتماعي المؤسس للدولة نفسها، فالدولة ضرورة يقتضيها العقل بالنظر إلى تشتت الأهواء وتضارب الآراء لتحقيق الكمال الإنساني ” كل إنسان مفطور على بلوغ الكمال والكمال لا يحصل إلا بالدولة، والدولة لا تتحقق في أرض الواقع إلا إذا تخلى كل فرد عن حقّه في التصرف وفق فكره الشخصي” وفقاً لـ”سبينوزا” وهي الضامن الوحيد لاستقرار المجتمع واستمرار الحياة، فهي تقوم برعاية وتنظيم مصالح الأفراد وضبط سلوكياتهم في العلاقات المادية والمعنوية فبفضل الدولة تتوسع دائرة الحريات وتتعمق فائدة ومصلحة الأفراد لأنها وجدت لحماية نفسها ومواطنيها، فلولا وجود الدولة لعمت الفوضى ورجعت البشرية الى الوراء فهي جهاز ضروري لتطور البشرية.
بالتالي نستنتج أن الدولة ضرورية لأنه لا يمكن أن يقوم المجتمع دون نظام سياسي يحكمه، فوجود الدولة مهم وكما قال “هيغل” الدولة أداة لترقية الحرية” .
ماذا يعني غياب الدولة! إن غياب الدولة يعني بالضرورة تفكك المجتمع المدني وانكفائه على منظومات فرعية، تستبدل الانتماء المدني أو الوطني الواسع، بانتماء فرعي أضيق، مناطقي او طائفي او عرقي او عائلي او حتى القومي الضيق (البنان-العراق –السودان على سبيل المثال لا أكثر)، وفي أحيان كثيرة قد يؤدي غياب الدولة إلى عدم القدرة على القيام بواجباتها وغلبة الانتماءات الفرعية (خصوصاً للبلدان الخارجة من استبداد طويل الأجل كالعراق وليبا) وكلها مقدمات لقيام حروب أهلية بين المنظومات الفرعية بهدف السيطرة على مزيد من الأرض أو اكتساب المزيد من القوة أو مصادرها (العراق وقبلها لبنان المثال الحي على ذلك)، خاصة في ظل غياب تقاليد ديمقراطية راسخة تمكن المجتمع من إعادة بناء الدولة بعد انهيارها، كما حصل في لبنان أثناء الحرب الأهلية، وفي هذه الحالة قد تبدو المنظومات الفرعية بحاجة الى ضامن خارجي لإعادة اللحمة الاجتماعية واعادة بناء الدولة… لكن وفق أنظمة مصالح تلك الدول.
إن أول ما يختفي من مقومات الدولة هو الاقتصاد وآخر ما يتم بناءه عند إعادة بناء الدولة، لأنه المرآة لباقي نواحي الحياة في الدولة، فالاقتصاد إكسير الحياة للدولة، ويلعب دورا أساسياً ومهماً في حياة الدولة كما الفرد، ويعني استمرار بقائها وهو عنفوان شبابها الدائم، ومنه تمتلك الدولة أسباب القوه والأمن والرخاء تحت مظلة سيادتها، ومن خلال اقتصاد قوي تستطيع بناء مجتمع قوي فاعل، وبدون اقتصاد قوي تكون الدولة رهن للمساعدات الخارجية في سد حاجات مواطنيها مما يعني أن المجتمع مرهون لإرادة المانحين ومصالحهم وهذا يقود الدولة لأن تصبح دولة فاشلة ..
وتعرف الدولة الفاشلة بأن مؤسسات الدولة “العامة” فيها، لم تتمكن من تقديم نتاج سياسي اقتصادي اجتماعي مناسب وهو سببا في وقوع شرعية الدولة، وهو ما سيولد عجزاً عن تأمين الاستقرار والأمان وافتقارها إلى نظام قضائي مستقبلي لمعالجة القضايا والخلافات، إضافة إلى عجزها عن إعادة تنظيم البنى التحتية للبلاد أو ضمان نوع من الرعاية الاجتماعية للمواطنين والأهم من كل ذلك فشلها في ترسيخ روح المشاركة السياسية في عملية الحكم، وإن أهم السلبيات التي تقود إليها الدولة الفاشلة تتلخص في:
1. المكونات المختلفة في الدولة الفاشلة، فبدلا من أن تتعايش بشكل اختياري وتعمل معاً، إنما تتباعد و تتنافر.
2. ليس لدى مثل هذه الدولة إمكانية السيطرة على الحدود الذاتية وحماية وحدة أراضيها.
3. الملاحظ في الدولة الفاشلة تصاعد استمرار العنف وارتكاب الجرائم بشكل أعمال عنف وتطرف.
4. تكون المؤسسات فيها فاسدة وعاجزة عن تقديم الخدمات للمواطنين، تماما كما يحصل الآن في الدولة السورية، والخوف من استمرار هذه الحالة بعد سقوط النظام، كنتيجة لتماهي النظام السابق بجسد الدولة السورية وترسيخ ثقافة الفساد، لذا يجب التفكير بكيفية توفير خدمات للماء أو الكهرباء للمواطنين .
5. في الدولة الفاشلة تخفق البنى التحتية للبلاد وتعجز عن أداء دورها، وبالتالي تتفشى البطالة والفقر، ونحن من خلال المشروع الوطني رغم تأخر انشاءه “لسنّا في صدد شرح الأسباب” نحاول ان ننّحي الدولة السورية من الوصول الى الدولة الفاشلة.